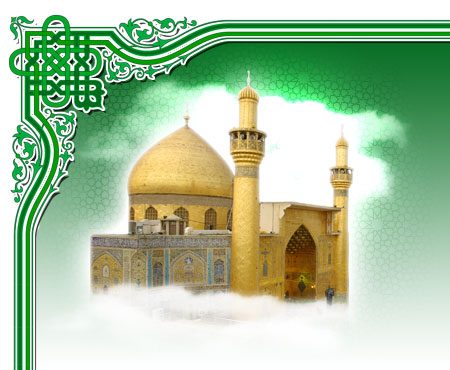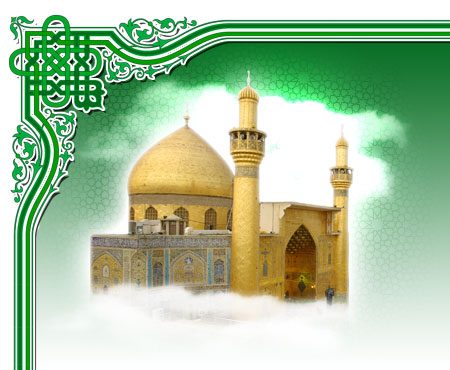كانـت القضيـة الحسـينيّة ولا تـزال حيّـة وتثير الإهتمـام عبـر التاريـخ، فمـا جـرى فـي سـاحة الطّـف مـن سـفك الدمـاء الطاهـرة وتضحيـة أهـل البيـت عليهـم السلام ليســت ســبباً لخلودها فقــط بــل تعتبــر حركة نســاء الطــف ولاســيّما زينــب (ع) رمـزا للخلـود وبقـاء النهضـة. فأكملـت زينـب(ع) هـذه الحركـة حيث أدت الـدور الرئيسـي أمـام الأعـداء الظالمين وجهـاء الأمـة- فـي تبيينهـا الأهـداف والحقائـق. ويركّـز المقـال علـى دراسـة الـدور الإعامـي لزينـب(ع) عبـر كلماتهـا بمـا خطبـت أمـام يزيد خطبـة غـراء، ويـدرس أسـاليب احتجاجهـا واقناعهـا وتبكيـت العـدو، ويبحــث عــن الخصائــص الحجاجيــة لهــذه الخطبــة مــن الناحيــة البلاغيــة والأسـلوبية، فتوصـل البحـث إلـى أن العقيلـة الهاشـمية بمنطقهـا الجزيـل وبقولهـا الفصــل ونطقهــا الفصيــح اســتدلت بالآيــات القرآنيــة والأحــداث التاريخيــة لتفضـح العـدو، وهـي تسـتخدم أسـاليب التقابـل والتضـاد لتنقـض نتيجـة المعركة وتسـتخدم سـلمية الخطـاب الإقناعـي التأثيريـة، لتثبـت أحقيـة أهـل البيـت (ع) وزيـف الأعـداء وأحاديثهـم الملفقـة لتقنـع المتلقي.
المقدمة
ثـورة عاشـوراء لـم تتـم فـي سـاحة الطّـف فحسـب، بـل أنجـزت بعـد مـا قامـت زينــب(ع) بدورهــا الإعلامــي، وكشــفت الســتار عــن حقيقــة ســفك الدّمــاء فــي ســاحة الطّــف، وحاولــت أن تبيّــن حقائــق حركــة الحســين(ع) وأصحابــه عليهــم السلام. هكذا تـم التلازم بين السـيّدة وأخويهـا السـبطين عليهـم السلام للتمهيـد لمـا سـتقوم بـه العقيلـة زينب(ع) لتكـون القطـب الثانـي الـذي تـدور عليـه نهضـة الإمـام الحسـين(ع) وهـي فـي أعلـى درجـات الشـعور إليهـا، وهـذا هـو سـر اصطحابه(ع) للسـيّدة زينـب(ع) لأنّهـا وعـت أسـباب النّهضـة الحسـينيّة. التزمـت السـيدة زينـب (ع) التزامـاً كاملاً بوصيـّة الإمـام الحسـين(ع) التـي تبيّن مهمتهـا الجسـيمة التـي لابـد مـن الإضطـلاع بهـا قبـل نزولهـا النهائـي للميـدان. فخطبـت زينـب(ع) خطبـة غـرّاء فـي مجلـس يزيـد إذ أبهـرت السّـامعين بمـا أوتيـت مـن الحكمـة وفصـل الخطــاب، وبمــا تمكنــت مــن فنــون اللّغــة العربيّــة فاســتطاعت أن تكشــف مــن خلالهـا زيـف الأعـداء. فبلغتهـا البليغـة وكلامهـا الفصيـح قد خاطبـت الناس على مقـدار عقولهـم ومبلـغ قدراتهـم، فأوصلـت مـا تبتغيه إليهـم من خلال وسـائل بلاغية إقناعيـة، أي تلـك الوسـائل التـي اسـتمدت اقنـاع المتلقين من الإبـداع البلاغى من خلال توظيـف الوسـائل المفضيـة إليـه، واسـتخدمت الحجّة والدليليـن النّقلـي والعقلـي لإقنـاع السـامعين ولاسـيّما مـن القـرآن الكريـم الـذي حفظتـه واسـتحضرته فــي جميــع حجاجهــا، وأحاديــث رســول الله (ص) والأقــوال المأثــورة عــن العــرب مــن الأبيـات الشـعرية السـائرة والأمثـال العربيـة.
قامــت الســيّدة زينــب(ع) بإنشــاد الكلام بالشــجاعة الفائقــة التــي تجلّت في الثبــات وعــدم الخــوف مــن الأعــداء والوقــوف بوجوههــم وكأنّهــا تمثلــت كلام رســول الله (ص): (أَلا إنَّ أفضل الجهادِ كلمةُ حقٍّ عند سلطانٍ جائر) [1]، فأبــدت الرضــا بقضــاء الله تعالــى وأظهــرت رباطــة الجــأش وعــدم الإنكســار أمــام الأعـداء. إنّهـا بحسـن منطقهـا وقـوّة حجتهـا، قـد ذكّـرت النـاس بمنطـق أبيهـا الإمـام علـي بـن أبـي طالـب (ع) وقـد سـلكت السـبيل القويم فـي إفحـام الخصـوم متوخيـة ما أراده الله في الدعوة إليه في قوله سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [2].
فهــذا المقــال يهتــم بدراســة الجانــب البلاغــي للخطبــة ليكشــف الجانــب الإقناعــي لخطبــة زينــب(ع) فــي مجلــس يزيــد بالمنهــج الوصفــي التحليلــي ليجيــب عن: مــا هــي آليــات الإقنــاع فــي خطبــة زينب؟ آليــات الإقنــاع لخطبــة زينــب (ع) فــي مجلــس يزيــد.
هيكلية الخطاب التأثيرية
حسـبما هـو المتـداول فـي سـيرة الأبـرار مـن أهـل البيت(ع) عنـد إنشـاد كلام وكلمــة؛ فبــدأت زينــب(ع) الخطبــة بالقــرآن الكريم مفتتحــة بــه خطبتهــا لتشــد أذهـان الحاضريـن إلـى القـول ويسـود الصمـت عليهـم؛ كـي يكـون أبين لحجتهـا وأوضـح لقصدهـا، ولتعلـم السـامعين بأنهـا تنتمـي إلـى ديـن الإسلام؛ لئلا يكـون بعضهم قد أووهــم بأنّهــم غير ذلــك. ثــم وصفــت عاقبــة الذيــن أســاءوا بالسّــوء فاختــارت مــن آيات القــرآن قـولاً أوفــق للمناســبة، وأكّــدت علــى الكــذب فــي كلام الأعـداء وفعلهـم بمـا هـم قـد نطقـوا بالتّسـليم لديـن الإسلام، لكـن اسـتهزأوا بتطبيقهــم لأحكامــه لتعــي الأجيال بــأنّ القــول بلا فعــل تكذيب واســتهزاء. ثــم عرجــت مــن العمــوم بالقــول إلــى تخصيــص يزيــد بــن معاويــة مــن بيــن الحضــور (أظننــت يــا يزيد) فخصّتــه بالخطــاب واصفــة إيــاه وواصفــة لعملــه، فأشــارت إلــى عقيدة باطلــة يحملهــا مصدرهــا الظنــون المريضــة، بكونــه اســتطاع أن يأخــذ عليهــم بأقطــار الأرض عندمــا قطــع عليهــم طريــق الإصلاح وحــرّم عليهــم العيــش إلّا تحــت ســلطانه، وإلّا فطريــق الرّافضيــن لحكمــه القتــل، وقــد نفّــذه بالحسـين وآل بيتـه عليهـم السلام ليسـكت كل من تسـوّل لـه نفسـه الثـورة علـى سـلطانه، ويقطـع أنفـاس دعـاة الحـق ويسـتعرض بعملـه هـذا للحضـور عنده. ثـمّ أشارت إلـى أنّ هـذا الملـك الـذي أنـت فيـه ملكنـا وسـلطاننا ولـم ننازعـك علـى ملـكك، وإنّ مـا أنـت أخذتـه عنـوة وظلمـاً، فلـم نطلـب فـي نهضتنـا هـذه غيـر حـق مغتصــب. ثــم تــرد أوهامــه المريضــة وظنونــه الهاوية بقولهــا: (مهلاً.. مهلاً..)؛ للتحذيــر والوقــوف عــن الغــي أنســيت قــول الله تعالــى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.[3]
فأوقفتـه علـى حقيقـة أوهـام مـا يعتقـد، وأوضحـت سـخف هـذا القـول بدليل قرآني آخـر احتجّـت بـه عليـه، لتذكّـره والحاضريـن بقـول الله فـي ذلك. ثـم أوضحـت صغـر شــأنه بيــن النــاس فقالــت: «أمِــن العــدل يابــن الطلقــاء» فاســتبعدت أن يصــدر ممـن كان أصلـه الدنـاءة، حيـث ينتمـي إلـى جدّتـه (هنـد بنـت عتبـه) التـي لاكت بفمهـا كبـد الحمـزة بـن عبـدالمطلـب فـي غـزوة أحد؛ تعبيراً عمّـا تحمله مـن أحقاد وأضغـان علـى مـرأی ومسـمع مـن أجـداده، «وكيف يسـتبطئ في بغضنـا أهل البيت مـن نظـر إلينـا بالشنف والشـنآن والإحـن والأضغـان؟»! فلا يرتجـى أيّ خيـر كانـت شـجرته بهـذه الخسّـة ونفسـه مليئـة بالأحقـاد والكراهيـة... وأشـارت إليهـم بــأنّ الــذي يقودهــم هــذا (يزيــد) والــذي كان أجــداده أولئــك لايــزال علــى ملّتهم ودينهـم وسـجيتهم وأضغانهـم، لا يتأثّـم ولا يسـتعظم التصريـح بالكفـر وعـدم إيمانـه بالدّيـن الإسلامي، لذلـك استشـهد بقـول (عبـدالله بـن الزبعري) بعـد وقعـة أحـد:
لأهلّوا واسـتهلّوا فرحـاً ثـم قالـوا يـا يـزيد لا تشـل و هو يقصد:
لعبت هاشم بالملك فلا خبرٌ جاء ولا وحي نزل
وسـتقف أمـام الله العـادل محاكماً، لذلـك قالت: «كـد كيدك، واسـع سـعيك، وناصـب جهدك، فـوالله لاتمحـو ذكرنـا، ولا تميـت وحينـا، ولا تـدرك أمدنـا» فعبـرت عـن ثقتهـا بالهـدی الـذي هـم عليـه وبالطريـق الـذي سـلكوه، ولا تهمنـا تخرصـات الأعــداء وأحقادهــم، فســيظهر الله أمــره، وســيتم نــوره ولــو كرهــت أنــت وأشــباهك وســتلاحقك لعنــة التاريخ. وختمــت خطبتهــا بالحمــد الــذي افتتحــت بــه فتقول: «فالحمـدلله الـذي ختـم لأوّلنـا بالسـعادة والمغفـرة (إشـارة منهـا إلـى جدّهـا رسـول الله (ص) وقـول الله تعالـى له) :ليغفـر لـك الله مـا تقدم من ذنبـك ومـا تأخر و يتـم نعمتــه عليــك و يهدِيَك صراطاً مســتقيماً» ولآخرنــا بالشــهادة والرحمــة (إشــارة منهـا الـى الحسـين). فأوجـزت فـي القـول، وأبلغـت فـي الخطـاب، وأحسـنت فــي الموعظــة، وجمعــت الأغــراض المتعــددة فــي ألفــاظ سلســلة المنهــل بعيــدة المــدی [4].
سلميّة الخطاب للتأثير
الخطـاب لإقنـاع المتلقّيـن وتفنيـد المخالفيـن وإبلاغ الفكـرة للتأثيـر علـى المخاطبين لابدّ وأن يُجـری حسـب المعاييـر الخاصّـة البلاغيـة، فلابـد أن يبـدأ مـن نقطـة خاصّـة وينتهـي إلـى نقطـة خاصّـة ليجلـب لفـت انتبـاه المتلقّيـن، ويجعلهم يواكبـون معـه إلـى الخاتمـة والنتيجـة المنشـودة. الخطبـة الزينيبـة فـي مجلس يزيد فــي تلــك الأجــواء المضنية ســارت ممنهجــة فــي الإلقــاء فكانــت خطاباً حواريّاً طرفـاه (مرسل ومتلق)، مـع وجـود مقصديـة التأثيـر والإقنـاع، وقـد أشـار جـو الخطبـة إلـى الرفـض والتمـرد وقـد تآلفـت صياغتهـا فـي حركـة متناسـقة يـؤازر بعضهـا بعضاً وهنـاك سـلّم فـي التـدرج للتأثيـر.
الإستهلال
هــو ابتــداء الخطــاب بالوعــظ والإرشــاد والتحذيــر، واســتدراج المعانديــن أو الخصــوم، حيــث يضــع الخطيب النـّـص وموضوعــه أمــام المتلقــي، ليزيــل عنــه الغمــوض ليتابــع بالإهتمــام. فائدتــه هــو أنّــه يدل علــى الغــرض الــذي يســتهدفه الخطـاب، أو اسـتمالة المتلقي واسـتدراجه لقبـول الخطاب والموضوع، ومـن ثم كان الإهتمـام بالإفتتـاح لأنّه أول مـا يقـرع السـمع وبـه يسـتدل علـى ما في الرسـالة فيدفع المتلقـي إلـى التنبـّه والإصغـاء، فالعتبـة النصيّة أول مـا يلتقـي فيهـا قـارئ النـص بصاحبــه، والبداية هــي المحــرّك الفاعــل الأول لعجلــة النــص. فالخطبــة الزينبيــة وبالإهتمـام بهـذا الجانـب تقبـل علـى المتلقـي بموضـوع إثبـات الحـق، وحججهـا آيـات الله سـبحانه وتعالـى بتفخيـم وتعظيـم للآيـات والتّشـويق إليهـا مـن خـلال حـث المتلقّـي علـى إنجـاز فعـل المواصلـة للإقنـاع بقـوّة الدليـل وظهـور الحجـة.
العرض
وهـو الجـزء المنتصـف بيـن المقدمـة فـي الخطبـة وخاتمتهـا، فهنـاك وحـدة موضوعيـة ونفسـية فيـه تتناسـب مـع أجـزاء الموضـوع الواحـد، وفيـه الإنسـجام أی التواصـل مـع المتلقّـي للخطـاب. فالخطبـة الزينبيـّة باسـتخدام الآليـّات الإقناعيـّة مــن الأســاليب الكلاميــة والأدوات التأثيريــة تســتدل بالحقائــق والآيــات القرآنيــة لتشـنيع عمـل يزيـد وأعوانـه فـي عـرض الخطـاب.
الاختتام
يعلــق غالباً فــي الذّهــن، وذلــك لقــرب عهــده بالقــراءة، وتوحــي بنهايــة تختـم الخطبـة الزينبيـة بـ: (والحمـدلله رب العالمين، الـذي ختـم لأوّلنـا بالسـعادة والمغفـرة ولآخرنـا بالشـهادة والرحمـة ونسـأل الله أن يكمـل لهـم الثـواب، ويوجـب لهـم المزيـد ويحسـن علينـا الخلافـة، إنّـه رحيـم ودود، وحسـبنا الله ونعـم الوكيـل) [5].
فقـد احتـوت هـذه الخاتمـة علـى الوظيفـة الحجاجيـة فـي قضية الإعتـراف بالقـوّة الإلهيــة، والرضــا بالقضــاء وعظمــة الخالــق، وعلمــه بــكل شــيء، وبدايــات الأمور وخواتيمهــا بيــده فهــو الخبيــر. وقــد أكّــد الخبــر بالجملــة الطلبيــة الدعائيــة التــي حــوت الفعــل الكلامــي (نســأل الله) ورفــد بالجمــل المؤكدة بــ(إنّ) التــي تحمــل طاقــة حجاجيــة كامنــة فــي رد التــردد أو الشــك فــي ذلــك (إنــه الله رحيــم ودود)، فتثيـر انفعـالات نفسـيّة وتضـع المسـتمع علـى هيئـة حسـنة وتثبـت صحّـة الأقـوال الموجهــة إليــه ليميــل للمتكلـّـم فهــذا هــو إصــدار حكــم نهائــي ومخلــص وافــي للحجــج.
الأساليب الكلاميّة
تكثــر الســيّدة زينــب(ع) مــن اســتخدام أســاليب الطلــب كالإســتفهام الإنـكاري والأمـر والنّـداء والتمنـّي واسـتعمال الأخبـار الطلبيـة والإنكاريـة التـي يكثـر فيهـا التوكيـد بأنواعـه المختلفـة للإفـادة منهـا فـي المحاججـة والإقنـاع، لكـي تفحم الخصـوم وتزيل شـك (المتلقيـن) في مـا تـورد مـن أخبـار توضـح ثـورة أخيهـا الإمـام الحســين (ع).
الأساليب الطلبيّة
الإسـتفهام بمعنـاه الحقيقـي هـو طلـب الفهم، فللإسـتفهام فاعليـّة مـن حيـث الإنجـاز والتأثير، بـأنّ غاية السـؤال أنـه يطلـب مـن المخاطـب أمـراً لـم يسـتقر عنـد السـائل، وكذلـك ماهيـة السـؤال هـي طلـب الحصـول علـى أمـر مبهـم فـي الذهـن يهـم السـائل ويعنيـه، إلّا أنّ الإسـتفهام يخـرج عـن معنـاه المعهود إلى معـانٍ مجازية لهـا قـوّة إنجازيـّة وفاعليـة فـي التأثير. أمّا إذا خـرج الإسـتفهام عـن حقيقتـه ليـؤدي معنــى آخــر فهــو الإســتفهام البلاغــي، ومنــه الإســتفهام الــذي يــؤدي معنــى النفــي
ويسـمى اسـتفهام الإنـكار، واسـتفهام الإنـكار المتضمـن معنـى النّفـي يـؤدي دوراً أقـوی وأبلـغ مـن النفـي. أمـا النفـي بصيغـة الإسـتفهام الإنـكاري فيـؤدي وظيفتيـن:
أولهمـا: النفـي، وثانيهمـا: إنّ المتكلـم إذ يُلقـي كلامـه بصيغـة الإسـتفهام، فـإن ذلك يدل علـى الثقـة التـي تمـلأ نفسـه، لأنـه ُيلقـي كلامـه وهـو يدرك أنـه لـو كان فـي كلامـه أدنـى ريب لـردّه عليه جوابـاً عـن اسـتفهامه.
وردت فــي مأثــور العقيلــة نصــوصٌ فيهــا يكثــر اســتخدام الإســتفهام فــي تركيب إقناعي ممتزجاً بأساليب طلب أُخــری كالأمــر والنهــي. وتتراكم الاسـتفهامات فـي خطبـة زينـب (ع) صريحـة مـرة وضمنيـة أخرى لغاية الإنكار والبرهــان علــى بطلان أفعــال يزيــد وحزبــه الطلقــاء إذ تقــول: «أظننــت يــا يزيــد حيــن أخــذت علينــا أقطــار الأرض وآفــاق الســماء، فأصبحنــا نُســاق كمــا تســاق الأســاری، أنّ بنــا هوانــاً علــى الله، وبــك عليــه كرامــة، وأنّ ذلــك لعظــم خطــرک عنده فمهلاً مهلًا، لا تطـش جهلًا. أنسـيت قـول الله تعالـى: "ولا يحسبنَّ..." [6]
والملاحـظ علـى النـّص، إنّ السـيّدة (ع) حشّدت ألوانـاً مـن التراكيب فـي نـص واحد ولاسـيّما أسـاليب الطلب وسـخرت طاقات اللغة التعبيرية لإقناع السّـامعين بمـا تقولـه فـي ذلـك الموقـف العصيـب، مركّزة علـى أن مـا حصـل بـإرادة الله التـي سـتعيد الأمـور إلـى نصابهـا. إنّهـا سـخّرت مـن يزيـد مـن خـلال بيـان سـذاجة تفكيـره الــذي لايليــق بالحكّام فــي قولها: «تضــرب أصدريك فرحـاً، وتنقــض مذرويــك مرحا» (نفــس المصــدر)، فــي تقســيم صوتــي جميــل، وتــوازن موســيقي مســتقطب للأسـماع. أطالـت زينـب(ع) فـي وصـف قبـح أفعـال يزيـد وفـي هتـك سـتر أهـل البيـت (عليهـم السلام) فاسـتخدمت أسـلوب الإطنـاب شـارحة مقـدار الألـم الـذی حـلّ بهــا لســخف فعــل يزيــد ومزجــت الســيّدة (ع) بيــن أســلوب الإســتفهام الــذي تخللـه الوصـف وأسـلوبين طلبييـن آخرين وهمـا: الأمـر فـي قولهـا: (مهلاً مهلاً) وهـو المصـدر النائـب عـن فعـل الأمـر الـذي يعمـل عملـه: أي تمهَّـل ودع مـا أنـت عليـه. وأسـلوب النهـي فـي: (لا تطـش جهلاً) والملاحـظ علـى هـذا النهـي، التقريـع وعـدم الإحتــرام؛ لأن المقابــل طائــش جاهــل فحذّرتــه وبأســلوب فعــل الأمــر (مهلاً مهلاً) لتواسـي قلبهـا المجـروح والوعـد بعـذاب الله ليزيـد وأعوانـه.
نفـت السـيّدة زينـب (ع) ظـن يزيـد بهوانهـم علـى الله، بالاسـتفهام الإنـكاري بقولها: «أظننـت يـا يزيد».. و إن دلّـت علـى شـىء فإنّمـا تـدل علـى (قـوّة القلـب، وثبـات القـدم، والإيمـان الصّادق والعقيـدة الرّاسـخة) إذ تقــول: «أمــن العــدل يا ابـن الطلقــاء تخديرك حرائــرك و إمــاءك وسـوقك بنـات رسـول الله سـبايا؟! قـد هتكـت سـتورهن، وأبديـت وجوههـن، تهـدو بهــنّ الأعــداء مــن بلــد إلــى بلــد وتستشــرفهنّ المناقــل ويتبــرّزن لأهــل المناهــل، ويتصفـح وجوههـن القريـب والبعيـد الغائـب والشـهيد والشـريف والوضيـع، والدني والرفيـع، ليس معهـن مـن رجالهـن ولـي ولا مـن حماتهـن حمـي، عتـوا منـک علـى الله وجحــودا لرســول الله، ودفعــاً لمــا جــاء بــه مــن عنــد الله...؟! ».
قــد اتضــح مــن النص أسـلوب طلبـي آخـر هو النـّداء فـي قولها: «يابن الطلقـاء» أنّهـا تنـادِ بـ: (يابـن الطلقـاء). قـال ابـن الأثيـر: «الطلقـاء هـم الذيـن خلّى عنهـم يـوم فتـح مكـة وأطلقهـم، فعيـل بمعنـى مفعـول، أي طليـق بمعنـى مطلـوق، وهـو الأسـير الـذي أُطلـق عنـه إِسـارُه وخُلِّي سـبيله» وهـم الذيـن أعلنـوا إسلامهم فـي فتـح مكـة وهـم يبطنـون الكفـر، وهـم الذيـن قـال لهـم رسـول الله: «اذهبـوا فأنتـم الطلقـاء» و«مـن دخـل بيـت أبـي سـفيان فهـو آمـن» آمـن وليس مؤمنـاً، قـال تعالـى: ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾.
السـيّدة زينـب(ع) بهـذا القـول تكشـف الغطـاء عـن هويـة يزيـد، وترفـع السـتار عـن أصلـه وحسـبه ونسـبه وهـذه الجملـة هـي إشـارة الـى مـا حـدث يـوم فتـح مكـة والظّاهـر أنّ السـيّدة زينـب (ع) تقصـد مـن هـذه الجملـة معنييـن لتـوازن لـه بيـن حســن خلق جدّهــا رســول الله (ص) وتعاملــه الكريــم مــع أجــداد يزيــد الطلقــاء، وهــم رؤوس الكفــر يومــذاك علــى الرغــم مــن حربهــم لــه، وســوء تعامــل يزيــد اليــوم مــع بنات الرسول (ص) ومقابلته الإحسان النبوي بالإساءة الأمويـّة. وقـد تهـدف السـيدة زينـب(ع) أن تذكّـر يزيد بأنـّه ابـن الطليقيـن الذين أطلقهما رسـول الله (ص)مع أهل مكة وكأنّهـم عبيـد، تذكيرًا لـه بسـوء سـوابقه المخزية وملـف والـده وجـدّه كذلـك تذكيـراً ليزيـد بالإحسـان الـذي بذلـه رسـول الله (ص) لأسلاف يزيـد حيـث أطلقهـم، فقالـت: (أمـن العـدل؟) أي هـل هـذا جزاء إحسـان رسـول الله (ص) مـع أسلافك أن تتعامـل مـع حفيـدات الرسـول (ص) هـذا التعامـل السـيء. ومـن تلـك الإسـتفهامات المنكـرة لهـذا الفعل الشنيع ليزيد: ( وأنّى يُرتَجَى مُراقَبَةُ مَن لَفَظَ فُوهُ أَكبادَ الشُّهداء). وتمازج الإسـتفهام بالمفعـول لأجلـه المبيـن للأسـباب مـن خـلال ثلاثـة مفاعيـل لأجلهـا معطوفـة بعضهـا علـى البعـض الآخـر؛ وذلـك لكشـف زيـف الإيمـان الـذي يدّعيه يزيـد، ويسـتحق برأيـه تنصيـب نفسـه خليفـة علـى المسـلمين وهـي: (عُتـواً منـك علـى الله) و (جحـوداً لرسـول الله) و(دفعـاً لمـا جـاء بـه من عنـد الله).
يعـد أسـلوب «الأمـر» مـن أكثـر الآليّـات التـي يسـتخدمها المرسـل الموجـه لمـا لـه مـن دور كبيـر فـي تبليـغ مقتضـى الأفعـال التوجيهية. والمطّلـع علـى الخطبـة الكريمــة يجــد أنها تضمنــت أفعــال الأمـر التــي جــاءت علــى سبيل المجــاز، والهـدف منـه تعجيز الخصـم و إفهامـه أنـّه الخاسـر مهمـا سـعى ودبـر فقالـت: «فكِد كيدك، واسـع سـعيك،وناصب جهدك، فـوالله لاتمحـو ذكرنـا، ولا تميـت وحينـا، ولا يرخص عنك عارها وهـل رأيـك إلا فنـد، وأيامـك إلّا عدد، وجمعك إلّا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنــة الله علــى الظالمين». إنّ الأفعــال (كد،ناصب،اســع) هــي أفعــال أمــر موجــهة مــن مرســل يملــك الحــق والفصاحــة والبيــان والثقــة العليــا القــادرة علــى الإنجــاز إلــى مرســل إليــه فــي مرتبــة دنيــا لا يملــك القــوة ولا الإنجــاز ولذلـك بين المرسـِل (زينـب الحـوراء مدعومـة بثقـة الله وقوتـه وقدرته) والمرسَـل إليه (يزيـد الطاغـي) تباعـد كبير. إن الله تعالـى لمـا أثبـت ربوبيتـه و إلوهيتـه تعالـى لـكل الخلـق، وأراهـم خلقـه وتدبيـره وكلّفهـم أن يـروه شـيئاً مـن خلـق آلهتهـم، فليـس لـه التدبير. إنهـا حجـج قلبـت موازيـن الحرب المتوجـه نحـو يزيد فيها معنـى التعجيز ورميه بالوهـن والضعـف لأنـه فـي ضلال مبيـن واضـح.
واســتخدمت زينــب (ع) لام الأمــر واســم فعــل الأمــر فــي ســياق بيــان مصيــر يزيد مسـتدلة بنـص قرآنـي، كل ذلـك مقرونـاً بأسـاليب القَسَـم المؤكـدة لصدقهـا، والحجـب لهـا مكشـوفة وهـي تنظـر بعيـن الله لما سـيحيق بيزيـد من عـذاب فتصرّح: «ولَتَـرِدن علـى رسـول الله (ص) بمـا تحمّلـت مـن سـفك دمـاء ذريته وانتهكـت من حرمته فـي عترتـه ولحمتـه، حيـث يجمـع الله شـملهم، ويلهـم شـعثهم، ويأخذ بحقهـم ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾
للنفـي أثـرٌ فاعـل فـي النـص التداولـي، لأن غرضـه إبطـال آراء الخصـم وردهـا، فللنفي وظيفة إقناعية (تفتت أســس الــرأي المضــاد وتنــزع عنــه المصداقيــة)، وتغلـب اعتقـاد المتلقي وتقطـع ادّعاءاتـه. ولـه وظيفـة تتمثـل فـي إبطـال معلومة الخصــم، و إمــداده بمعلومــة أخرى يعتبرها الآخر صحيحة، أي أنها وظيفة التعويــض علــى أنّــه ســابق للنفــي كمــا يــری علمــاء اللغــة، فالمســتكبر يزيــد هــو المخاطب، سـماعه وعدم سـماعه واحد لأنّ الخطبة تتوخّي النتيجة. فالمسـتكبر يزيـد سـمع الحجـج ووعاهـا لكنّـه لاسـتكباره لـم يعتـرف والخطبـة قطعـت ادعـاءه بإظهـار النتيجـة: «فـوالله يـا يزيـد، لا تمحـو ذكرنـا، ولا يرخص عنك عارهـا». كل ذلك جـاء فـي سـياق متناسـق يشـدّ بعضـه بعضـاً بالحجـج الدامغـة، فـأول النفـي قسـم آخــره كان أســاليب نفــي مجــازي ب (أداة الحصــرو إّلا) أو (الاســتفهام الإنــكاري): (وهـل رأيـك إلّا فنـد وأيامـك إلّا عـدد وجمعـك إلّا بـدد.»...كل تلـك أسـاليب نفـي مؤكـدة أظهـرت النتيجـة الحاسـمة الحقائـق التـي لا مـراء فيهـا وأدلّة مقنعة فالحياة إلى زوال، وكلٌّ سـينال مـا قدمـت يـداه.