|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 77639
|
|
الإنتساب : Mar 2013
|
|
المشاركات : 741
|
|
بمعدل : 0.16 يوميا
|
|
|
|
|
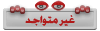

|
كاتب الموضوع :
alyatem
المنتدى :
المنتدى الفقهي
 بتاريخ : 08-04-2013 الساعة : 08:41 PM
بتاريخ : 08-04-2013 الساعة : 08:41 PM
ثالثاً: الذهنية المعاصرة
على الرغم مما يتوفر عليه الشيخ الفضلي من عمقٍ فقهي على نحوٍ خاص وإسلامي على نحو عامٍ على مستوى الموروث العلمي، إن كان من ناحية المضمون والمحتوى أو من حيث الآليات والأدوات، فإنه لا يخفي – مع أصالته هذه – ميلاً كبيراً لتفعيل الفقه والانطلاق به في مسارات جديدة تلبي حاجات المجتمع المعاصر وتستجيب لتطلعاته.
وقد لايتسع المجال في مثل هذه الدراسة الوجيزة لمتابعة الشيخ الفضلي بما يتصل بهذه الخصيصة غير أننا نشير إلى عدة مواضيع تُدِلُّ على هذه الروح وتشير إلى هذه الذهنية:
1- ما يتصل بما اصطلح عليه أخيراً بالاجتهاد الجماعي، حيث عرض له الشيخ الفضلي رأى أن الآية الكريمة في قوله تعالى:{فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} لم تتعرض لكيفية ممارسة الاجتهاد – فلم تعرب عن لزوم اقتصار المجتهد على الاجتهاد الفردي – كما أنها لم تشر إلى أن له أن يمارس الاجتهاد الجماعي. وهذا يعنى أنه يمكن أن يكون فردياً ويمكن أن يكون جماعيا، لأن كلاً منهما يصدق عليه أنه اجتهاد، والاقتصار على الجانب الفردي منه إنما هو من باب الأخذ بأظهر المصداقين، إتباعا للوضع المألوف للاجتهادات الأخرى في العلوم الأخرى في تلكم العصور<(23).
2- عالج الشيخ الفضلي الروايات التي وردت في تحديد سن اليأس عند المرأة في ضوء المعطيات العلمية، ولذلك وضع ما ورد من الروايات في اعتبار اليأس عند القرشية في سن الستين، واعتباره في سن الخمسين عند غيرها في سياقها العلمي، وذلك في ضوء ما انتهت إليه التجارب العلمية والأبحاث الطبية التي أخذت بالاعتبار مجموعة من العوامل منها ما هو بيئي ووراثي وغير ذلك، بما يدعو إلى حمل الروايات التي حددت اليأس بالستين للقرشية على المثالية(24).
3- في موفقه من ولاية المرأة للوظائف العامة، ومنها القضاء ورئاسة الدولة، حيث وضع الشيخ الفضلي هذه المسألة في سياق تغيّر واختلاف الزمان، إذ – من وجهة نظره – فإن "اختلاف الزمان يتدخل في اختلاف المستوى لتحمل المسؤولية، فيوم كانت المرأة ربة بيت فقط غير مفسوحٍ لها المجال في تعلم العلم والتزود بالثقافة العامة والخاصة التي تسهم في بناء المجتمع ورفع مستواه إلى ما هو أفضل كانت غير مؤهلة للقيام بأعباء المسؤوليات الكبار. أما اليوم حيث فسح لها المجال للتعلُّم والتزود بالثقافة، وممارسة مختلف المهارات العلمية والفعاليات الاجتماعية، وأثبتت قدرتها من خلال التجارب على تحمل أعباء المسؤوليات الكبار، أصبحت لا تختلف عن الرجل في ذلك، وهي وإياه على صعيد واحد من حيث المستوى والقدرة"(25).
ولم يُشر الشيخ الفضلي إلى هذا السياق كونه دليلاً شرعياً على موضوع البحث، فإنه بحث المسألة وموضوع البحث من حيث الدليلية وفقاً لما جرى عليه الفقهاء، إلاّ أنه أشار إلى هذا السياق كونه مؤشراً على تغيّر الزمان وتأثير ذلك على تبدّل الموضوعات.
رابعاً: البُعد العلمي
ويُلاحظ في منهج الشيخ الفضلي غلبة الرؤية العلمية، وهيمنة المنهج العلمي ومعاييره في العرض والنقد والتقييم، وهو ما يفسَّر حرصه على تتبعّ الأقوال والاتجاهات والنظريات في موضوعات بحثه، دون أن يضع قيوداً نفسية تصده عن بعض الأقوال والاتجاهات والنظريات، فهو يدأب على الاحاطة بهذا التعدد والتنوُّع، قديمه ومتأخره وجديده، في محاولةٍ منه لإغناء البحث بهذا التنوع، وإشاعة الهم العلمي والمعيار المعرفي واعتباره المرجع في النقد والتقييم.
وفي ضوء هذه الحقيقة استبعد الشيخ الفضلي المعيار المذهبي للتقييم، وكذلك نأى بنفسه عن الرؤية الشخصية في ذلك.
وقد كتب تعليقاً على رأي الشيخ الكاشاني في (الغناء) وما تعرَّض له من هجوم واتهام له بالتأثر بآراء علماء أهل السنة، ومنهم الغزالي: "...وبعد هذا، بقى لنا أن نقول:
1- إن اختيار الرأي العلمي وتبنيه من قبل عالم آخر ظاهرة علمية شائعة شيوعاً علمياً لا مجال لإنكاره، ولا طريق للمؤاخذة عليه.
2- كون الرأي لغير أبناء المذهب ليس سبباً مسَّوغاً للرفض، ونحن نرى وبالوجدان أن مسائل الاتفاق بين علماء المذاهب الإسلامية أكثر بكثير من مسائل الخلاف، فهل يسوَّغ لنا هذا أن نرفض مسائل الاتفاق والوفاق؟!
3- إن اختيار الرأي يأتي على نحوين: الأول: اقتناع العالم الآخر بصحة دليل صاحب الرأي وسلامته، وهذا شيء مُسلَّم به لا غبار عليه. الثاني: وجدان العالم الآخر في أدلة مذهبه الخاصة ما يسند هذا الرأي الذي اختاره.
وهذا هو ما فعله الكاشاني، حيث وجد صحيحة أبي بصير المتقدمة وأمثالها مما يدعم رأيه ويصوَّبه، وقد اعترف له بهذا صاحب الحدائق بقوله: "وما ذكره وإن أوهمه بعض الأخبار" وهذا البعض من الأخبار الذي أشار إليه لا يمنع من ناحية الاجتهاد أن يكون موهماً في رأي فقيه، وغير موهم بل مقرر في رأي فقيه آخر.
قلت هذا لأوضح – من ناحية منهجية – المفارقة التي وقع فيها منتقدو الكاشاني بتوهم أنه تبع الغزالي تقليداً، فليس هو – وكما رأينا – بالفقيه المقلد، وإنما هو مجتهد منفتح، يختار ويعتمد الدليل في إطار مذهبه"(26).
ولذلك دعا الشيخ الفضلي إلى وقفة متفهمة ومتأنية مع الآراء العلمية غير المشهورة، ومنها ما كان بصدد التعليق عليه، وهي مسألة حرمة الغناء وكونها عرضية وليست ذاتية كما هو مشهور الفقهاء والمعروف عندهم(27).
بل لاحظ الشيخ الفضلي الآراء الفقهية في المذاهب الفقهية الأخرى، واعتبر كفاية وجود رأي خلاف المشهور لديها في رفع الوحشة لدى العلماء والفقهاء في مذهب مختلف للإفتاء بهذا الرأي أو بحثه بطريقة مختلفة ومغايرة عّما عليه المشهور، كما ظهر في ولاية المرأة للوظائف العامة ومنها القضاء، وأشار إلى رأي ابن جرير الطبري المفسَّر في هذا المجال(28).
خامساً: المرجعية القرآنية
لا يختلف اثنان من المسلمين في كون الكتاب الكريم (القرآن) مرجعاً أساسياً للتشريع، فهو المصدر الأول للتشريع عندهم، غير أن هناك اختلافاً على المستوى المنهجي في علاقة القرآن الكريم بالسنة الشريفة، مما يتصل بالترتيب الذي يشغله القرآن الكريم بالنسبة للسنة الشريفة إذ قد يُلاحظ على المنهج الفقهي السائد – مع الاعتراف بالمرجعية القرآنية – التعاطي مع السُنة الشريفة بمستوى واحد وبمسافة واحدة من القرآن الكريم، في وقت يؤكد فيه عدد من الفقهاء على ضرورة قراءة نصوص السنة الشريفة وتفسيرها في ضوء الكتاب القرآن، لأنه المصدر الأول للتقعيد، ولا ينفصل – عندئذٍ – أي نصٍ أو موقف عن الإطار العام للنص القرآني.
وتبدو هذه الإشكالية في عددٍ من المسائل الحرجة، ومن ذلك مركز المرأة القانوني في ضوء بعض النصوص الشرعية، ومسائل أخرى مهمة تتصل بالشأن الحياتي العام.
وبما يتصل بمنهج الشيخ الفضلي يمكن أن نشير إلى عدة نقاط ترتبط بهذه الإشكالية بنحوٍ من الأنحاء:
1-في مسألة ولاية المرأة للوظائف العامة ومنها الولاية السياسية والقضائية، استدل بعض الفقهاء – وربما هو مشهور الفقهاء – بأدلة قرآنية وأخرى من السنة الشريفة على نفي مثل هذه الولاية.
ومن أهم ما استدل به قوله تعالى: {الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}، وخاض الفقهاء جدلاً فيما بينهم حول تفسير هذه القيمومة – والتي تعني عندهم (الولاية) – وهل أنها شاملة وعامة أو أنها تختص بالبيت الزوجي.
وربما يتفردّ الشيخ الفضلي في هذه المسألة بقراءة أقرب ما تكون إلى السياق القرآني، إذ أنه بعد الإشارة إلى ما يعنيه هذا اللفظ (قوّامون) وأنه ليس حقيقة شرعية ولا مصطلحاً فقهياً، أشار إلى ما ورد في القرآن في مادة (قَوَم)، وانتهى إلى ما أفاده نصاً: "ونستفيد من هذا أن القوّامية لا تعني القيمومة التي فهم منها المستدلون التسلط والتصرف وإنما تعني إناطة مسؤولية رعاية مصالح النساء وتدبير شؤونهن بالرجال. ومن أظهر مصاديق تلك الرعاية وذلك التدبير، هو وجوب إنفاق الرجل (الزوج) على زوجته، وهذا يعني أن الأنفاق من القوّامية، وليس من القيمومة، وقد يرجع هذا إلى أن أكثر المجتمعات – ومنها المجتمعات العربية التي نحاول معرفة معنى القوّامية لديهم – مجتمعات ذكورية، تحمَّل الرجل مسؤولية رعاية مصالح المرأة وتدبير شؤونها، وهم لا يرمون من هذا إلى أن تلك الرعاية وذلك التدبير هما من نوع الولاية السلطوية، وإنما هما شأن من شؤون تركيبة المجتمع ...ونخلص من كل ذلك إلى أن القوّامية غير القيمومة.."(29).
2- وقد تظهر المرجعية القرآنية عند الشيخ الفضلي في ضوء ما ذكرناه بدرجة أكثر وضوحاً في مسألة حرمة (الغناء) وأنها حرمة عرضية أو ذاتية، حيث يعمد الشيخ الفضلي إلى إرجاع الروايات التي وردت في تحريم الغناء إلى القرآن نفسه، وهو ما تم الإرجاع إليه في الروايات ذاتها. ففي رواية أبي الصباح الكناني والتي فيها "عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل {والذين لا يشهدون الزور} قال: هو الغناء" اعتبر الشيخ الفضلي أنه لابد من حمل جملة (يشهدون) على معنى (يحضرون)، والمناسب لذلك هو حمل الغناء على إرادة مجالس الغناء(30)، لأنه هو المعنى الذي يلائم مجالس الغناء، ولذلك فإنه على رأي الشيخ الفضلي >إذا حملت على المعاني الأخرى، فإنه لا يتم الاستدلال بالآية... وهذا يعني أن الغناء لم يحرَّم لذاته وإنما لأسباب خارجة عنه تعرض له فتكسبه الحرمة.."(31).
3- وفي مسألة السلام مع (الكيان الصهيوني) يشير الشيخ الفضلي إلى مفارقة وقع فيها غير واحدٍ لتبرير وتسويغ السلام مع هذا الكيان، وذلك استناداً إلى قوله تعالى: {وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم}.
وقد ذكر الشيخ الفضلي في ردّ هذه الدعوى أمرين(32) :
الأول: أن موضوع قضيتنا يختلف عن مصاديق هذه الآية الكريمة، ذلك إن قضية فلسطين أرض إسلامية استلبت، فالحكم الشرعي يفرض استردادها وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين وهم المسلمون. وما تصدق عليه الآية الكريمة هو الكفار المحاربون الذين هم في ديارهم وأوطانهم لا في دار للمسلمين اغتصبوها من المسلمين، وسياق الآية في القرآن الكريم واضح بوصفه قرينة على ذلك.
الثاني: إن الحكم في آية السلم مرحلي انتهى بنزول سورة البراءة.
وقد استند الشيخ الفضلي في رأيه في كون الحكم مرحلياً ودعّمه برأي سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن).
وإذا كان الشق الأول الذي أشار إليه الشيخ الفضلي صحيحاً، من جهة عدم صدق هذه الآية على (الكيان الصهيوني)، فإنه يلاحظ على الشق الثاني في أن اعتبار الحكم الوارد في الآية الكريمة مرحلياً غير مسلّم، بل إن الشيخ الطوسي صرَّح بوضوح بأن الحكم عام ولم ينسخ، كما أفاد ذلك في تفسيره (التبيان في تفسير القرآن).
سادساً: رؤى مستقلة
ولعلّ من المفيد أن نشير إلى ما يتمتع به الشيخ الفضلي من استقلال في الرؤية، مما ظهر في عددٍ من أبحاثه الفقهية، سواء كان ذلك على مستوى الرأي الفقهي نفسه أو على المستوى المنهجي، كما ظهر ذلك بوضوح في رأيه في مسألة حرمة الغناء، وانتهى إلى أن حرمة الغناء ليست ذاتية كما هو مشهور الفقهاء، بل أن حرمته لجهة العوارض، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في مطاوي هذه الدراسة.
كما ظهر ذلك في تدعيم الرؤية الفقهية بخصوص تولّي المرأة للوظائف العامة ومنها القضاء، على خلاف ما هو المشهور، كما مرّت الإشارة.
وعلاوة على ذلك، لا يترك الشيخ الفضلي مجالاً دون أن يمرّ إن كانت هناك ضرورة للتنبيه على مفارقة أو ملاحظة.
ومن المستحسن أن نشير إلى عدة ملاحظات نوّه بها الشيخ الفضلي:
1- في ما يعرف بالشبهة الموضوعية، لاحظ الشيخ الفضلي على هذا الاصطلاح الأصولي أن الأفضل والأصوب أن يقال: الشك الموضوعي، بمعنى الشك في الموضوع أو عوارض الموضوع، وذلك لأن الشبهة والشك لفظان مترادفان، فعندما يقال الشك في الشبهة الموضوعية، فإنه يكون المعنى: الشك في الشك، وهو بلا شك ولا شبهة، غير مقصود(33).
2- فضّل الشيخ الفضلي أن يؤخذ بمصطلح المرجع (الأفقه) بدل مصطلح (الأعلم)، لأنه أوضح في تعريف المفهوم والدلالة على المعنى(34).
3- لاحظ الشيخ الفضلي على اصطلاح الحدث الأصغر والحدث الأكبر عند الفقهاء في باب الطهارة، أنه تعبير غير صحيح، وهو من باب التسامح، وذلك لأنه لا يقال الأصغر إلاّ إذا كان هناك صغير، وكذلك الأكبر، ولذلك فالأصوب أن يُسميا بالحدث الصغير والحدث الكبير، ويقال: الأحداث الصغيرة والأحداث الكبيرة(35).
4- وقد لاحظ الشيخ الفضلي على التعبير الشائع لدى الفقهاء – أو بعضهم – عن الاجتهاد وأنه (تحصيل الحجة على الحكم) بأنه جاء من واقع الأعمال الفقهية الاستدلالية التي قام بها الفقهاء، حيث تركزت في معظمها على شرح المتون الفقهية، بينما المطلوب هو أن ننظر إلى وظيفة المجتهد من واقعها، لا من واقع الأعمال التي يقوم بها الفقهاء، وذلك لأن واقع وظيفة الاجتهاد هي البحث في النص الشرعي (الكتاب والسنة) لاستنباط الحكم منه، والفقيه عندما يرجع إلى النص الشرعي الذي هو الدليل لاستفادة الحكم منه، إنما يرجع إليه بعد أن يفرغ من إثبات حجيته وثبوت صحة الاستدلال به، ثم يقوم باستنباط الحكم منه(36).
هذه بعض ملامح البحث الفقهي عند الشيخ الفضلي، لعلها أوضحت بعض ما يمكن إيضاحه في هذا الصدد.
والحمد لله رب العالمين
___________________
الهوامش:
(1) الفضلي، التقليد والاجتهاد، ط2 /2006م، نشر مركز الغدير، بيروت /88.
(2) المرجع السابق نفسه/ 108.
(3) المرجع السابق نفسه/ 109 وما بعد.
(4) الفضلي، الرأي الفقهي في حلق اللحية، بحث منشور في مجلة المنهاج عدد 21/48.
(5) الخميني، روح الله، الاستصحاب/ 220، ط أولي/ 1417هـ نشر مؤسسة تنظيم آثار الإمام الخميني.
(6) الفضلي، عبد الهادي، دروس في فقه الإمامية ج2/ 3-4، ط أولى 1419هـ، نشر مؤسسة أم القرى.
(7) الفضلي، التقليد والاجتهاد/ 154، المرجع السابق.
(8) الفضلي، المرجع السابق نفسه 161-162.
(9) الفضلي،دروس في فقه الإمامية ج1، 665، ط1995، نشر مؤسسة أم القرى.
(10) الفضلي، التقليد والاجتهاد، المرجع السابق/69.
(11) المرجع السابق نفسه/ 71.
(12) الفضلي، (بحث) ولاية المرأة في الإسلام، المنشور في مجلة المنهاج العدد (39)/ 12- 13.
(13) الفضلي، دروس في فقه الإمامية، ج1/ 480، المرجع السابق.
(14) الفضلي، التقليد والاجتهاد، المرجع السابق، ص96/ 98.
(15) الفضلي، بحث (بيع العربون) منشور في مجلة (المنهاج) عدد 15 /51.
(16) الفضلي، الغناء/ 70، ط2 /2001، نشر مركز الغدير/ بيروت.
(17) المرجع السابق نفسه/68.
(18) الفضلي، (بحث) ولاية المرأة في الإسلام، المنشور في مجلة المنهاج العدد 39/20.
(19) الفضلي، التقليد والاجتهاد، المرجع السابق/ ص131.
(20) المرجع السابق نفسه/ 129.
(21) الفضلي، الغناء، المرجع السابق/ ص50.
(22) المرجع السابق نفسه/ 51.
(23) الفضلي، التقليد الاجتهاد، المرجع السابق/225.
(24) الفضلي، دروس في فقه الإمامية، المرجع السابق ج1/338.
(25) الفضلي، ولاية المرأة في الإسلام (بحث) منشور في مجلة المنهاج، العد(39)، /ص32.
(26) الفضلي، الغناء، المرجع السابق، ص71 - 72.
(27) المرجع السابق نفسه/62.
(28) الفضلي، ولاية المرأة في الإسلام، المرجع السابق ص34.
(29) الفضلي، ولاية المرأة في الإسلام، مجلة المنهاج، عدد (39) المرجع السابق/ ص18 -19.
(30) الفضلي، الغناء، المرجع السابق، ص53.
(31) المرجع السابق نفسه/61.
(32) الفضلي، الرأي الفقهي في السلام مع إسرائيل (بحث) منشور في مجلة المنهاج العدد، 13/ 14-15.
(33) الفضلي، دروس في فقه الإمامية، المرجع السابق، ج1 /361.
(34) الفضلي، التقليد والاجتهاد، المرجع السابق/93.
(35) الفضلي، دروس في فقه الإمامية، المرجع السابق 1 /364.
(36) الفضلي، التقليد والاجتهاد، المرجع السابق ص185/ 186.
| |
|
|
|
|
|