|
|
عضو ذهبـي
|
|
رقم العضوية : 36059
|
|
الإنتساب : May 2009
|
|
المشاركات : 2,809
|
|
بمعدل : 0.50 يوميا
|
|
|
|
|
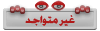

|
المنتدى :
منتدى القرآن الكريم
 المدخل الأساسي إلى فهم القرآن الكريم
المدخل الأساسي إلى فهم القرآن الكريم
 بتاريخ : 03-07-2009 الساعة : 07:31 PM
بتاريخ : 03-07-2009 الساعة : 07:31 PM
المدخل الأساسي إلى فهم القرآن الكريم
* * * * * * *
د. عبدالسلام أحمد الراغب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يتميّز القرآن الكريم عن غيره من الكتب المألوفة لدينا، بطريقة عرضه لموضوعاته.
فقد اعتاد المرء أن يقرأ كتاباً معيناً في موضوع واحد، موزّع على أبواب وفصول، بأسلوب تأليفي، منسجم مع الموضوع الأساسي له.
ولكنّ القرآن يختلف عن ذلك. فهو يعرض موضوعات عدة، بطريقة خاصة به، تنسجم مع طبيعته وغايته. باعتباره كتاب هداية للبشر، ومنهج حياة.
وموضوعاته تدور حول هذه الغاية منه، مثل:
العقائد، والأخلاق، والأحكام، والقصص، وتاريخ النبوة والأنبياء، والدعوة، ومشاهد القيامة، ومشاهد الطبيعة، والإشارات العلمية فيها، ونماذج للمؤمنين، وأخرى للكافرين، وثالثة للمنافقين، والترغيب والترهيب، والعبرة والإعتبار، والزجر والتخويف.
وقد تتكرّر هذه الموضوعات، بين حين وآخر، بأساليب مختلفة، حسب السياق الذي يقتضي ذلك، لتحقيق العظة والإعتبار منها.
وقد تتداخل هذه الموضوعات في السورة الواحدة. فتبدأ السورة بموضوع، ويُدخل فيه موضوعٌ آخر. وهكذا تتكوّن السورة من موضوعات عدّة، دون أن تخلّ بوحدتها، وتماسكها، ومعالمها الأساسية.
وقد يتغيّر المخاطب والمتكلم في السياق الواحد، فينتقل بغتة من المخاطب إلى المتكلم إلى الغائب. وقد ينتقل من مشاهد في الدنيا إلى مشاهد في الآخرة، أو قد يعرض مشهداً من مشاهد القيامة، يتخلله مشهد من مشاهد الدنيا.
هذا التلوين الأسلوبي، والتنويع في الأداء الفني، يهدف إلى تحقيق التأثير في المخاطب أو القارئ. من خلال عرض الفكرة الواحدة، أو الموضوع الواحد، بأساليب شتى، تحقيقاً لغرضه الديني. إذ ليس بصحيح ما يقال عن تشتت موضوعاته، وضعف الروابط بينها.
بل إنّ هذا التنوّع في أسلوبه، هو سرّ تفوّقه وإعجازه.
لأنّ هذا التنويع الأسلوبي قائم على "التناسق الفني" بين هذه الأنماط الأسلوبية.
ومهمة الدارس له، أن يكتشف هذا التناسق الفني ويتذوق ما فيه من جمال.
وهذه الطريقة الفنية تنسجم مع موضوعه، الذي يدور حول الإنسان، وعلاقته بالله سبحانه.
وتعريفه بخالقه وقدرته وعظمته، في الكون والحياة.
وتزويده بالمعرفة الحقّة، حول حقيقة الإنسان، ومصيره، وغاية وجوده الإنساني، وتاريخه الممتد إلى يوم الجزاء والحساب كما أنها تنسجم مع غايته، في تهذيب الإنسان وهدايته، وبنائه بناءً جديداً، على أساس التصور الإسلامي للحياة والكون والإنسان.
وقد اقتضت هذه الغاية المتوخاة منه، أن تتعدد طرائق أسلوبه، وتتميّز لغته وصوره؟، ويختص بنمط في التعبير، لا يُعرف في سواه.
فمرة يعرض الفكرة عرضاً مباشراً، ثم ينتقل إلى أسلوب الحثّ عليها، ثم يعرضها في أسلوب وصفي، ثم يعرضها في أسلوب قصصي، أو أسلوب الحكاية، أو أسلوب الحوار والجد، ومرة أخرى يغيّر في عرضها، فيقدّم ويؤخر، ويحذف ويذكر، ويوجز ويطنب، حتى يظلّ القارئ مشدوداً إليه، لا يملّ من أسلوبه، ولا يَخْلَق على كثرة ترداده وتلاوته.
حقاً إن موضوعاته تلك، لا يمكن أن تؤخذ مستقلة عن غيرها، أو تجرّد من سياقها.
إذ لابد من النظر إليها من خلال "رؤية كلية"، توحّد بين أجزائها، وتقيم الروابط فيما بينها، على ضوء "نظام العلاقات" التعبيرية والتصويرية والفكرية، الذي وضحته في كتابي "وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم".
فصورة الأرض مثلاً، تُعرض في القرآن الكريم بصور شتى، مثل: الطحو، والدحو، والمدّ، والبسط، والكفات، والقرار، والمهاد.
هذه الصور المختلفة، وردت في سياقات تستدعيها، وتتناسق معها.
فلابدّ للدارس أن يلم بالصور المختلفة للشيء الواحد، وينظر إلى ما بينها من ترابط وإنسجام وتناسق، ويكشف عن مدلولها السياقي المعجز، حتى يتوصّل إلى الرؤية الكلية والمتكاملة لذلك الشيء المدروس.
وما يقال عن هذه الظواهر الفنية والتعبيرية، ينطبق عليه تماماً ما يمكن أن يقال عن موضوعاته وأفكاره ومعانيه.
ومن الخطأ الكبير، أن يقبل الدارس على القرآن الكريم وفي ذهنه أنه "كتاب" يشبه الكتب الأخرى التي قرأها في حياته، وما فيها من تقسيم الموضوع إلى فصول وأبواب، أو أن يتناول موضوعه بشكل مستقل، يعرض كل ما يتعلق فيه في مكان واحد، بتسلسل وترتيب.
فموضوع يوم الحساب مثلاً، لا يعرض في سورة بعينها، وإنما يعرض موزّعاً على سور القرآن.
وكذلك قصص الأنبياء، لا تعرض في مكان واحد سوى قصة يوسف وإنما تُوزّع على حلقات قصصية في سور القرآن.
ولكن إذا ضُمّت هذه الحلقات، بعضها إلى بعض، نجد تكامل القصة بموضوعها وأحداثها وشخصياتها. وكذلك مشاهد القيامة، والموضوعات الأخرى، قد خضعت في عرضها وتوزيعها للطريقة ذاتها، لتحقيق التأثير والهداية والإعتبار.
لذا فإن الدارس المؤمن، ينطلق من طبيعة هذا الكتاب، المنزل على رسول الله (ص) بقصد هداية البشر، ودعوتهم إلى الله.
ولا ينطلق في دراسته، من تصورات مسبقة حول "تأليف الكتاب" في موضوع واحد، بتنسيق وترتيب، وأبواب وفصول.
فيقع في الأحكام الخاطئة.
ثم إن قواعد دراسته وفهمه تُستقى منه، وليس من أدوات خارجية عنه. إذ لابد لتلك الأدوات المعرفية، أن تنبع من داخل النص، لا من خارجه، ودراسته بأدوات مستعارة، أو مناهج مخالفة لطبيعته، سوف تقود صاحبها إلى التخبّط والظنون، والبعد عن روحه وغايته ومقصده.
2- ولا بد لقارئه، ما دام يريد فهمه، أن يعرف إبتداءً أنه منزَّل من الله على رسول الله (ص)، لتعريف الإنسان بخالقه وخالق الكون والحياة، وأن الإنسان مستخلف في الأرض، ومسؤول عن أفعاله وأعماله، وأنه متميّز عن بقية المخلوقات، في حمله مسؤولية الإختيار.
وقد أودع الله فيه كل ما يحتاجه، للقيام بهذه المسؤولية، من عقل وفكر وإرادة وحرية.
حتى يشعر بإستقلال "قراره"، دون مؤثرات أو ضغوط.
ولم يتركه سبحانه وتعالى دون إعانة ورعاية، وإنما ثبّت في فطرته بأن الله خالقه وخالق الوجود، وهو المتصرف فيه، ومالكه، ومدبّر شؤونه، وأنه راجع إليه للحساب.
وأسكنه "الأرض" سيداً متصرفاً وحراً، وتركه يتأمل فيها، وفي الحياة والوجود، ويتأمل آيات الله المبثوثة في الأشياء.
ليكتشفها بنفسه، ويدرك أسرارها وقوانينها، ومن ثمّ عظمة مبدعها وخالقها، فيسير على منهجه وهداه، مستنيراً وملتزماً، لا يحيد عن منهجه إلى سواه، فيضلّ ويتيه ويشقى.
وقد أعطاه الله هذه الحرية في الإختيار، ولم يتدخل في إيمانه، أو في غوايته وضلاله لأنّ هذه الحرية الممنوحة له، داخلة في إطار من وجوده على الأرض، للتجربة والإبتلاء والإمتحان.
وقد اقتضت مشيئة الله منذ خلقه، أن يتركه في فترة التجربة والإمتحان، لإختياره وقراره، ولكنه، رحمة منه، أنزل له كتاباً مقروءاً، ومنهجاً مقرراً، يساعده على معرفة الحقّ، واجتياز "الإمتحان" بنجاح إن أراد.
كما أنه أرسل رسولاً معلماً يوضح له ما في الكتاب، من دين قويم، ومنهج صحيح، وحق مستبين، وحساب وجزاء، ونعيم وعذاب.
وقد اختار الله محمداً (ص) نموذجاً إنسانياً لقرآنه، للسير على هداه، في الدعوة إليه، وإصلاح أوضاع الناس. وكان هذا القرآن هو كتاب الدعوة، ومنهج الإصلاح.
ويدور القرآن كله، حول موضوع الإنسان، ونجاحه وسعادته في الحياة، أو شقائه وخسرانه وضياعه:
فنجاحه وسعادته يرتبطان بالتزامه بمنهج الله، وسيره على هداه.
وفشله وخسرانه، حين يعرض عن منهج الله، إلى نظريات أو مناهج من وضعه وإنشائه، تحمل عجزه وقصوره عن فهم الحياة، وما بعد الحياة، متبعاً فيها هواه وغريزته، وحبّ التسلّط وقهر الآخرين، على حين أن منهج الله يحقق العدالة والمساواة بين البشر، لأنه لا يحابي أحداً على حساب أحد.
فالكلّ عباد الله، وهم متساوون، في الحقوق والواجبات والمسؤوليات والحساب والجزاء، أمام رب واحد يتصف بالكمال والجلال والجمال.
وغاية القرآن أن يدعو الإنسان الشارد إلى منهج الله، ليتفيأً ظلاله، ويتمتّع بنداوته. فيمتد تصوره، وتمتد حياته، ويتصل بهذا الوجود المسبح بحمده، اتصالاً حقيقياً في ظل العبودية لله. فإذا حياته ليست مقصورة على الحياة الدنيا المحدودة بزمن، وإنما تمتد إلى حياة أخرى، يحاسب فيها على أعماله. وإذا به يشعر أنه ليس وحده في هذا الوجود، وإنما هناك عوالم أخرى تسبح بحمد الله، فيأنس الإنسان بها، ويتواصل معها، في ظل العبودية لله الواحد القهار.
وينضم إلى "الموكب الكبير"، المتجه إلى الله، في الكون والحياة والوجود، تسبيحاً وحمداً. أمام هذا التصور الإسلامي للحياة والكون والإنسان. فيضبط سلوكه وفق شرع الله، ويشحذ همته في الدنيا، للبذل والعطاء ومساعدة الآخرين، في إقامة علاقات إجتماعية، قائمة على الحب والتآخي والأخلاق، في إطار شرع الله.
حقاً إن القارئ للقرآن أو الدارس له، حين يدرك أن موضوعه "الإنسان"، وغايته "دعوته إلى هذا المنهج"، يتبين له بجلاء أن هذا القرآن الكريم لم يحد عن موضوعه وغايته، وكلّ سوره وآياته، تتحد في موضوعه الأساسي، وغايته المطلوبة.
وحين يعرض القرآن مشاهد الطبيعة، وقصص الأولين، ومشاهد القيامة، وغيرها من الموضوعات، فإنه لا يهدف إلى تزويد الإنسان بمعرفة نظرية علمية أو فلسفية أو تاريخية أو طبيعية، وإنما يريد تصحيح تصور الإنسان عنها، وبيان الحقّ فيها، لإدراك عظمة الله وقدرته، بما يتفق مع طبيعة القرآن وغايته.
وقد وردت فيه إشارات علمية دقيقة، يعرضها بقدر معلوم، لا يتجاوز حاجة السياق إليها، ضمن هدفه وغايته وبحثه، دون تفاصيل، وقد بلغت هذه "الإشارات العلمية"، من الدقة، حدّ الإعجاز العلمي. يستفاد منها في الإستدلال على كون هذا القرآن الكريم وحياً منزلاً من عند الله، وليس من صنع البشر.
لأن معرفة الإنسان بهذه الإشارات العلمية لم تكن موجودة أنذاك، في علوم الأولين وحضارتهم، حتى يستقي منها الإنسان هذه المعرفة الجديدة.
وهذا دليل على أن هذه الإشارات العلمية فيه ليست مصدراً بشرياً، وإنما هي من وحي السماء، ذكرها الله تعالى في كتابه، دليلاً على قدرته وعظمته، في سياقات يقتضيها.
3- هذا القرآن لم ينزل من السماء دفعة واحدة، وإنما نُزِّل حسب سير الدعوة والظروف المحيطة بها، وظروف المؤمنين.
لذا لا نجده يتناول "موضوعه" كما ألفنا في الكتب التي نقرؤها، فهو كتاب فريد في موضوعه، وفريد في طريقة ناقص من مراعاة خصوصيته هذه، وطبيعته وغايته وهدفه، في أثناء دراسته.
ونحن نلمس فيه مراحل نزوله وأسبابها، من خلال مضمونه وشكله الأسلوبي، ففي المرحلة الأولى، كان تركيزهُ على شخصية الرسول (ص) لإعداده للقيام بمهمة الرسالة في عشيرته وأقاربه وقومه، مع تزويده بمعلومات ضرورية حول الحق الذي يدعو إليه.
ونقد ما كان عليه العرب الجاهليون، من ضلال وفساد في التصور والإعتقاد والسلوك. ودعوتهم إلى منهج الله، الذي يتضمن الأخلاق والسعادة والنجاح، فآمن من آمن، وكفر من كفر. وبدأ الصراع يشتد بين الفريقين.
وقد عُرضت هذه المعاني السامية، بلغة رفيعة جليلة، موجزة ومؤثرة، ذات إيقاع شديد، وفواصل قصيرة وسريعة، مناسبة للمرحلة الأولى، وظروف الدعوة، ومقتضيات الخطاب الأولى، في الحوار والإقناع والتأثير.
ثم جاءت المرحلة الجديدة في المدينة، وتغيّرت الأحوال والأوضاع والظروف. إذْ تأسست دولة الإسلام، لأول مرة في المدينة. وظروف "الدولة"، ومتطلباتها التشريعية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية، تختلف عن المرحلة الأولى في مكة، فكان القرآن ينزل، ليسدّ هذه الإحتياجات كلها، ضمن إطار غايته وهدفه في دعوة الإنسان إلى منهج الله سبحانه.
فكانت هذه المعاني والأفكار الجديدة، تعرض بأسلوب مختلف، يتناسب مع مرحلة الدولة ومهماتها، في توجيه المسلمين وتربيتهم، وتحذير المشركين والمنافقين، وحوار الكتابيين ودعوتهم، وبيان لتشريعاته وأنظمتها وعلاقاتها المحلية والدولية... إلخ.
ولكن القرآن الكريم لم يرتّب حسب نزوله وسير الدعوة، وإنما هو بين أيدينا بترتيب مختلف عن ترتيب نزوله، فنجد السور المكية تتخللها آيات مدنية، وكذلك السور المدنية تتخللها آيات مكية، وما نزل أولاً وضع في آخره، وما نزل متأخراً وضع في بدايته... إلخ.
والحكمة من وراء ذلك، أن القرآن لو جمع على ترتيب نزوله، ما كان هذا الترتيب مفهوماً للعصور التي تلت عصر النبوة.
فكان لابدّ من إضافة تاريخ نزوله، كملحق للقرآن، حتى يفهم ويحفظ، وقد شاء الله لقرآنه أن يجمع ويكتب ويرتّب نقياً خالصاً، كما أنزل، دون ملحقات توضيحية، تصرف قارئه عنه إلى تلك الملحقات التوضيحية. فكان على هذا الترتيب التوقيفي من الله، آية في إعجازه ودلالته، إذا تذكرنا أنه نزل في أماكن مختلفة وأزمنة متباعدة، ثم ضمّ ورتّب على هذا النسق المعجز، دون خلل أو اضطراب في معانيه وأساليبه، في نسيج محكم متناسق، ليكون برهاناً ملموساً على إعجازه وعلى صدق نبوة رسوله.
4- لا مجال للشك والإرتياب أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن نفسه المنزل على رسول الله، والذي قرأه على صحابته، وكان بين أيديهم بعد موته، دون تحريف أو تبديل.
وجدير بالذكر أنّ القرآن الكريم نزل بلغة قريش، ولكن أجيز في أول نزوله للقبائل الأخرى، أن تقرأه بلغاتها ولهجاتها، لأن هذا الأمر لا يؤثر في معناه، ولا في أحكامه، وإنما يسهّل عليهم تلاوته، وفهم معانيه وأحكامه، ويدرّبهم على أسلوبه.
5- القرآن الكريم نبع صاف فيّاض بالمعاني الإنسانية، ولا يفهمه إلا مَنْ أقبل عليه بصدق وعزيمة، وتخلّى عن أفكاره وتصوراته المسبقة، وأخلى ذهنه من هذه وتلك. وأقبل عليه بكليته، ليستخلص منه أفكاره وتصوراته، عن الحياة والكون والإنسان، وطريق السعادة الإنسانية، وما يشقي الإنسان ويدمّره ويهلكه.
أمّا الذين يقرؤونه، وفي أذهانهم تصورات وأفكار مسبقة، فإنما يقرؤون أفكارهم وتصوراتهم هم، ولا يقرؤون ما في القرآن من أفكار ومعانٍ وتصورات.
فلابدّ للدارس له أن يتجرد عن ذلك كله، ويعكف على "النص" ذاته محاولاً اكتشاف ما فيه من أفكار وتعابير وصور. فإنّ هذا القرآن لا يمنح كنوزه وأسراره إلا لمن أقبل عليه بعقل مفتوح، وقلب صاف، وأذن واعية، وقصد صادق لفهمه وإدراك أسراره.
وبعد هذه النية الصادقة للدراسة، تبدأ القراءة الجادّة له، لتكوين "معرفة إجمالية" لما يحتويه من المعاني والأفكار أو القضايا الأساسية، مثل العقيدة، والأخلاق، والدعوة، والسلوك الإجتماعي للفرد والأمة، والألوهية، وصفات الله سبحانه، والربوبية وآثارها في الكون والحياة والإنسان، وتاريخ الإنسان منذ وجوده إلى تاريخ انتقاله للعالم الآخر، وما في العالم الآخر من نعيم وعذاب، وأصناف الناس في الدنيا، من مؤمن وكافر ومنافق.
وهذه القراءة الإجمالية، لمعرفة القضايا الأساسية فيه، مفيدة في تكوين تصور صحيح عن النص المدروس، وإرجاع ما فيه من تفصيلات إلى تلك "الأصول" و"القواعد" الأساسية، التي يسعى القرآن بناء الإنسان عليها.
وبتكرار قراءته من أجل هذا الهدف، تتضح تلك القضايا، وترسخ في ذهن الدارس بقوة وجلاء، يتمكن بعدها من متابعة طريقة عرضه لتلك القضايا الأساسية، بأساليب مختلفة، وطرائق شتى مشوقة، في قراءات أخرى متكررة.
وفي كل قراءة يكتشف جديدا، في المعنى والأسلوب يضيفه إلى معلوماته، وقد يجيب على بعض الأسئلة التي دارتْ في خلده، أو خطرت له، في أثناء قراءته الأولى والثانية.
وبعد هذه "القراءة الإجمالية"، تبدأ "القراءة التفصيلية" للقرآن الكريم. فيُثَبِّت الدارس في ذهنه كلّ ما يتعلق بتعاليم القرآن الكريم، على وجه التفصيل لا الإجمال. فيدرس "المثل الإنساني" الذي يحبه ويفضّله، و"النموذج" المكروه والبغيض، ومن خلال عرضه للصفات والخصال النموذجية، تتضح صورة "الإنسان المطلوب"، بصفاته وخصاله وسلوكه وأفعاله.
ويتبين طريق سعادته ونجاحه، وطريق شقائه وتعاسته وفشله.
ويتابع الدارس تفاصيل تحقيق السعادة الإنسانية، من خلال مقاييس القرآن المعروضة فيه، وتفاصيل شقائه ودماره وهلاكه، وموجبات ذلك كلّه. وبهذه الدراسة الهادفة، التي تبدأ بمعرفة "كلياته" الأساسية، وما ينبثق منها من فروع، ثم متابعة تفصيلات هذه الفروع بكل أجزائها وذراتها، في دراسة كلية متحدة نامية، لا تنفصل لحمتها عن سداها.
وهكذا يتناول الدارس كل مسائل الحياة، من عقيدة وأخلاق، وحقوق وواجبات، وسياسة وإقتصاد وتشريع، وحرب وسلام، بالطريقة المذكورة نفسها، حتى تتضح كلّياته ومبادئه وقواعده أولاً، ثم تدرك "تفصيلاته" لتلك القواعد الأساسية.
6- أما القضية الأساسية في فهمه ودراسته، فهي أنّ هذا القرآن الكريم ليس كتاباً للإمتاع الفكري، وحشو الذهن الإنساني بالنظريات والأفكار والآراء، وإنما هو كتاب "دعوة وحركة"، للتطبيق والعمل والسلوك. فما إن تلامس آياته القلوب أو العقول، إلا وتُحْدَث فيها "هزة" أو إنقلاباً" أو "تغييراً" في التصور والتفكير والسلوك والعادات. وهذا ما كان من حال العرب، حين نقلهم من البداوة إلى الحضارة، ومن القبيلة إلى "الدولة والأمة"، ومن "الفوضى" إلى "النظام"، ومن الرؤية القاصرة إلى "الرؤية المستقبلية" الواعية.
إن دارسه لا يمكن أن يفهمه حقّ الفهم، ويصل إلى مكنونه الجوهري، إلا إذا آمن به وعمل بما جاء فيه، وقام بالدعوة إليه في مجتمعه، وعاش في الأجواء نفسها التي تنزّل فيها القرآن الكريم أول مرة، من الإيمان والعمل، والدعوة، والصبر على الأذى النفسي والمادي، وإجتياز المحن والشدائد.
حين يعيش دارسه في هذه الأجواء، يشعر بتوجيهات القرآن له، في كل خطوة يخطوها، وكل موقف. ويدرك معنى العناية الإلهية، على حقيقتها، محسوسة ملموسة، في تثبيته والأخذ بيده، وتعريفه بمن حوله من أفراد المجتمع، بشتى طبقاتهم وميولهم ونزعاتهم. ويشعر بحلاوة الدعوة إلى الله، وسعادته في تبليغها للناس، بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسلوب الرحمة والهداية.
ولابد أن نتخلّص من تلك الشوائب، التي علقت في أذهاننا من عصور الضعف والإنحطاط، من حصر مهمة القرآن في تلاوته على الأموات والمآتم، أو للبركة والتبرك والشفاء من العلل فقط، ونقبل على قراءته باعتباره "منهج حياة" للبشر، فيه هدايتهم وتنويرهم وسعادتهم وشفاؤهم وعزهم ومجدهم.
7- ويلاحظ دارس القرآن الكريم أنه يخاطب العرب، ويعالج أوضاعهم، وينتقد عقيدتهم الوثنية، فيظن من لا خبرة له ولا علم، أنه كتاب موجّه للعرب، دون غيرهم من الأمم، وأنه مرتبط بعصر وثني انقضى وانتهى، فلم يعد له دور مهم في حياتنا المعاصرة، فهو مرتبط بوقته وعصره وقومه.
هذا الكلام غير علمي، لأنّ أي كتاب يعرض منهجاً معيناً، وتصوراً جديداً، ويقدم مشروعاً حضارياً أو إصلاحياً لحياة الناس، لابدّ له من شواهد علمية وواقعية يشير إليها، ويناقشها، ويحللها من وجهة نظره الجديدة. وحين يفعل ذلك، ويقوم بهذا الدور، فإن أحداً لا يفهم هذا الكتاب بأنه مرتبط بوقته وعصره وقومه لمجرد حواره معهم، واستخدامه الأدوات المعروفة لديهم، أو الإشارة إلى أوضاعهم للإستدلال بها على قضية ما.
إنّ النقد الموضوعي لا يتفق مع هذا القول، ولا يجيزه، ولا ينظر إليه. لأن مهمة "الناقد" أن ينظر إلى القضايا الأساسية فيه، وإلى ما يقدمه من نظريات وأفكار، وتصورات عامة، احتواها الكتاب، ودعا إليها.
فالقرآن الكريم كتاب هداية للناس جميعاً، جاء لإصلاح أوضاعهم وأحوالهم، الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية. فهو منهج متكامل، وشامل لجميع شؤون الحياة، يخاطب "الإنسان" في كل زمان ومكان، بأسلوب بياني مشرق ومؤثر. وحين نجد فيه خطاباً للعرب، آنذاك، ونقداً لتصوراتهم الوثنية وأوضاعهم المنحرفة، فهذا من قبيل الإستشهاد على فساد "التصور الإنساني"، وفساد "العقيدة" و"النظام العام"، وقد برزت "عقيدة التوحيد" ونقاء "التصور الإسلامي" "النظام الإسلامي" من خلال طريقته في نقد العرب، والإستشهاد بأوضاعهم، على صحة ما يدعو إليه.
وقد اختار أسلوباً فريداً، في خطابه، وتقريره لهذه الحقائق الدينية، فهو يخاطب العرب من ناحية، ويخاطب "النوع البشري" من خلالهم، من ناحية أخرى. و"العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب". إن القارئ له الآن، يشعر أنه يخاطبه، ويعالج فكره وقلبه وروحه وسلوكه، ولا يشعر أنّ أسلوبه يتجه إلى غيره، أو لعصر غير عصره، أو لقوم آخرين، بل يشعر عكس ذلك. فهو خطاب للإنسانية جمعاء، لهدايتها ودعوتها إلى عقيدة التوحيد، وإصلاح أوضاعها وفق ما جاء فيه، ولا يستطيع أي جاحد لهذه الحقيقة أن يأتي بدليل علمي، على قصر مهمته على عصره وقومه.
8- إن مفتاح دراسة القرآن هو "اللغة العربية" بعلومها المختلفة، من نحو وصرف وبلاغة، فهي الأساس لفهمه واستيعابه، وإدراك توجيهاته، ومعرفة أسراره وإعجازه. لأنه نزل بها "قرآناً عربياً" واستثمر ما فيها من طاقات تعبيرية وتصويرية، وبلغ بذلك شأناً لا يرقى إليه أي كتاب آخر، أو أيّ عربي بليغ. وبذلك كان التحدي الأول للعرب. وما زال، فعجزوا عن مضاهاته ومعارضته، وأقروا بعجزهم قولاً وفعلاً، فكان عجزهم دليلاً له على صدق النبوة وصدق التنزيل.
آنئذٍ فهمه وحفظه ودراسته، ويمنع الفتنة فيه، والإضطراب في فمه وإدراك معانيه.
وقد قام العلماء المسلمون بجهود جبّارة لتفسيره وبيان غوامضه، وضبطه، حتى يسهل على الناس خدمة لكتاب الله سبحانه، فلم يتركوا شيئاً إلا وفصّلوه وبيّنوه وأحصوه، على نحو لم يسبق له مثيل. لأي كتاب آخر حظي بهذه العناية العلمية من قبل العلماء والباحثين على هذا الشكل الذي نراه للقرآن الكريم.
وقد نجد مَنْ حافظ في تفسيره على موضوعه وغايته ورسالته الإنسانية والحضارية للناس، والتزم قواعد اللغة العربية، في فهمه واستيعابه وعرْضه. كما نجد آخرين لم يلتزموا بذلك، ففسّروه بمنهج آخر مختلف، فابتعدوا عن موضوعه، ومهمته في تقديم نماذج للفرد والمجتمع والدولة، على أساس مبادئه التي قررها، في إطار هداية الناس ودعوتهم إلى منهجه وهداه.
فوقع الإختلاف بين المفسرين في تفسيره، ونقلت كتب التفسير هذا الإختلاف، حتى إنك لا تجد آية إلا واختلفوا في تفسيرها. والإختلاف- في الأصل- ليس مذموماً، لأنه يثري التفسير ويغنيه، ويفتح العقول لفهمه واستيعابه.
ولكنّ المذموم منه هو الذي ابتعد عن المنهج اللغوي في تفسيره، إلى عصبيّة مقيتة، وطائفية ذميمة، فأكثر هؤلاء من تأويلات مسائله، وابتعدوا عن روحه ورسالته، خدمة لأهوائهم ومذاهبهم، فلم يتجردوا عنها في أثناء إقبالهم على تفسيره، وإنما جرّوا "القرآن" لتلك الآراء والمذاهب، لتأييدها والدعوة إليها، فوقع الخطأ في فهمه وتأويله وتفسيره، فخرج التفسير عن إطار الإختلاف المقبول إلى الخلاف المذموم.
فلا بدّ للدارس أن يضع ذلك أمام عينيه، وهو يقرأ في كتب التفسير، فيقبل منها ما اتفق مع دلالته وسياقه، وتوجيهاته ورسالته، وخطابه للناس، ضمن دلالات اللغة العربية وإيحاءاتها، ويدع ما لا يتفق مع توجيهاته ورسالته ومبادئه.
المصدر: كتاب الدراسة الأدبية النظرية والتطبيق (نصوص قرآنية)
| |
|
|
|
|
|





